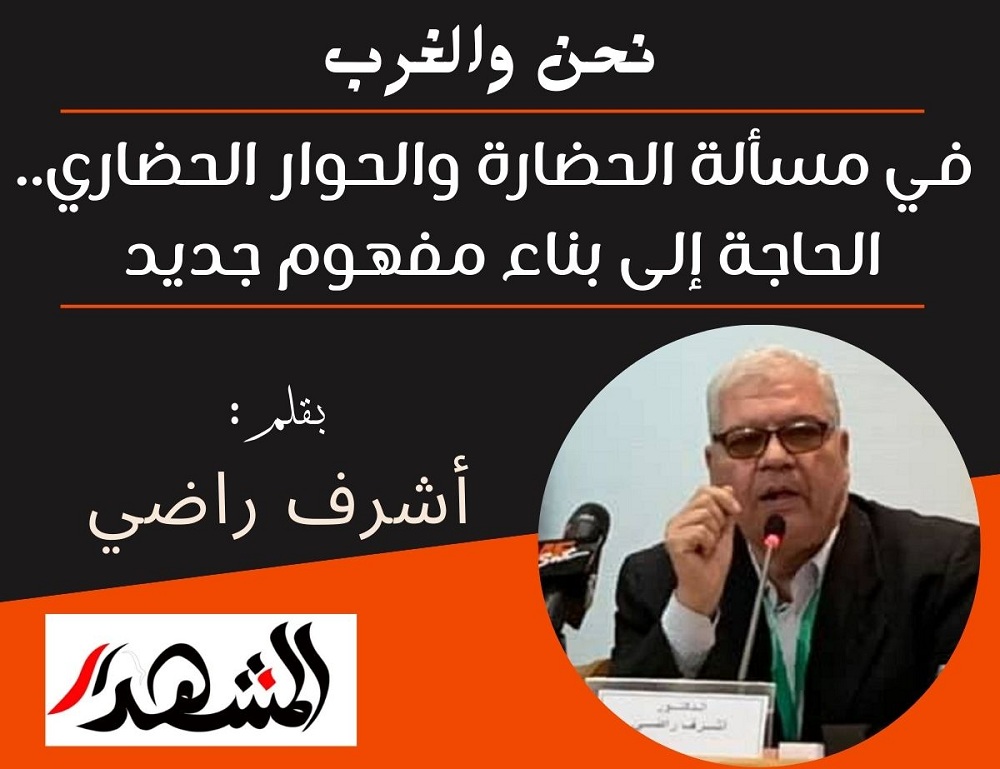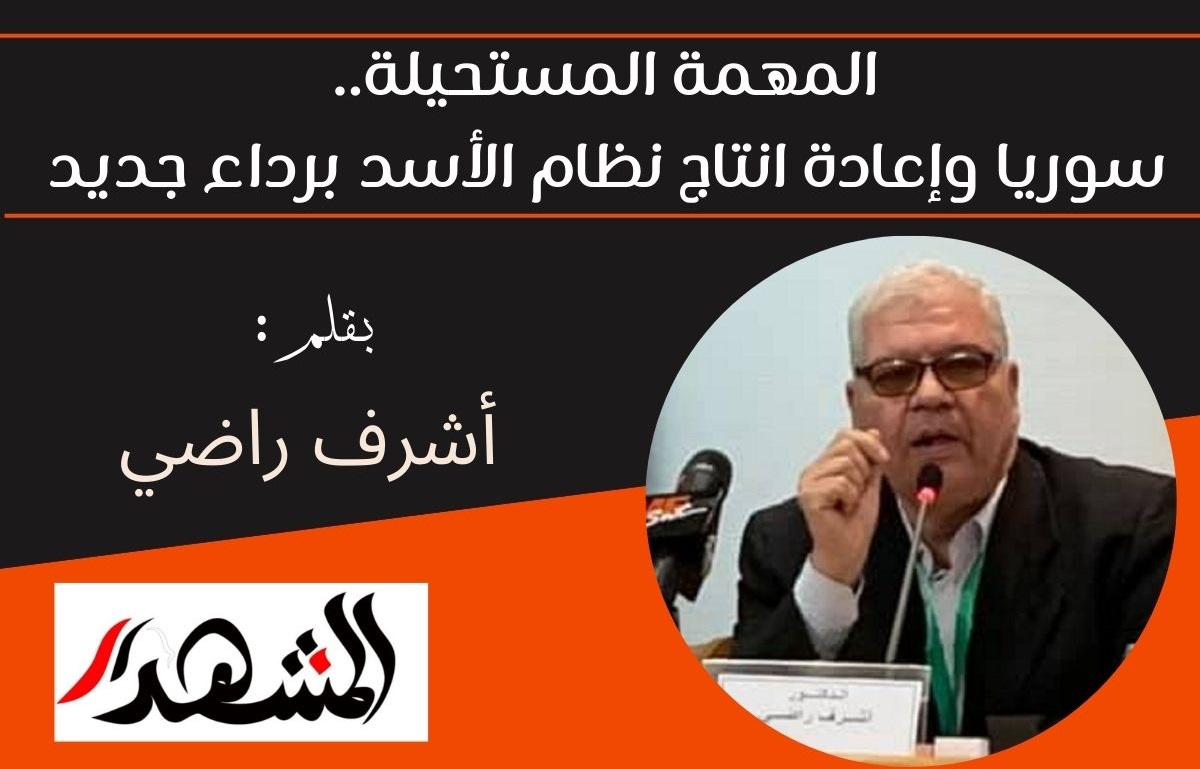يغلب على معظم المقالات التي كتبت في "نحن والغرب"، الانشغال بمسألة حوار الحضارات كبديل لصراعها. وتزايد الانشغال بهذه المسألة بعد أن نشر عالم السياسة الأمريكي صامويل هنتجتون مقالة "صدام الحضارات"، في فصلية "فورين أفيرز" في صيف عام 1993، ثم أتبع المقالة بكتاب نشره في عام 1996، بنفس العنوان لكن دون علامة الاستفهام في عنوان المقالة، وإضافة عبارة "إعادة صنع النظام العالمي". ولم ينقطع الجدل في العالم كله، منذ صدور هذه المقالة التي حاول مؤلفها تقديم نظرية جديدة لظاهرة الصراع الدولي في أعقاب تفكك المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي وانتهاء نظام القطبية الثنائية. كانت نظرية صدام الحضارات وغيرها من نظريات صدرت في تلك الفترة، تلبي حاجة التيار المحافظ، المهيمن على السياسة في الدول الغربية، إلى بوصلة جديدة توجه سياساته إزاء العالم. ونظراً لأن وجود عدو الخارجي، أو تهديد خارجي، حقيقي أو متخيل، يلعب دوراً محورياً في تفكير هذا التيار، ومن ثم في تحديد بوصلته، كان الحديث عن "الخطر الأخضر"، في محاولة لاستدعاء التهديد الإسلامي "للحضارة الغربية"، أو الحديث عن "الخطر الأصفر" في إشارة إلى ما قد تشكله الصين من تهديد لهيمنة الغرب وأحلامه الإمبراطورية. وسرعان ما صُبغ الحديث عن الحضارات بصبغة دينية واضحة، فانتقل الحديث إلى الصراع بين الإسلام من ناحية، وبين اليهودية والمسيحية من ناحية أخرى، حين تمت الإشارة إلى الأصول اليهودية والمسيحية لما يطلق عليه "الحضارة الغربية".
لم يلتفت كثير من المنخرطين في مناقشة نظرية صدام الحضارات، لاسيما الذين يطرحون الحوار بديلاً، إلى الخلل الرئيسي القائم في تلك النظرية والمتمثل في الخلط بين مفهومي الثقافة والحضارة، والتعامل مع العالم انطلاقاً من فرضية أنه مقسم إلى وحدات حضارية متجاورة ومتزامنة، بل والتعامل مع هذه الفرضية باعتبارها مسلمة لا تحتاج إلى اختبار، أو بديهية لا تناقش. واستتبع هذا الخلط المزيد من الخلط بين مستويات التحليل، الأمر الذي أدى إلى تشتت الرؤية وحصر التفكير في كيفية التعامل مع التحدي الذي يشكله الغرب، باعتباره المركز الحالي لعمليات التراكم التي تسهم في صياغة الحضارة العالمية الراهنة. والذي يتطلب مراجعة لمسألة الارتباط الوثيق بين النزعة الإمبراطورية من ناحية، وبين الادعاء الحضاري من ناحية أخرى. فقد أشار الدكتور عمار علي حسن في مقاله المنشور يوم 10 مارس، إلى أن الإمبراطوريات استخدمت في توسعها العسكري "مفاهيم حضارية كخطاب تحايلي يرمي إلى تبرير مسلكها العدواني التوسعي". لا أظن أن الإصرار على المدخل الحضاري أو المنظور الحضاري، وحصر الخلاف بين دعاة صراع الحضارات ودعاة الحوار بين الحضارات يُعينُنا على التعامل مع هذا التحدي، لما في هذا النهج من استمرار للخلط بين الثقافة والحضارة، الذي أراه مسؤولاً عن كثير من العيوب التي وصمت مبادرات الحوار بين الحضارات رداً على نظرية صراع الحضارات. فالمشكلة ليست في التوظيف السياسي لحوار الحضارات، أوأن هذا الحوار محصور في نطاق النخب ولا يصل إلى القطاعات الأوسع من الجمهور، وإنما المشكلة الأساسية في ذلك الخلط بين الثقافة والحضارة.
قد يعود إصرار الكثير من المثقفين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية على مسألة المنظور الحضاري إلى حقيقة أن الحضارة الإسلامية كانت هي الحضارة العالمية السابقة مباشرة على الحضارة الراهنة، وأنها تراجعت في مواجهة الغرب الاستعماري المتقدم والمتوسع عالمياً، وشعورهم بالقلق وعدم الارتياح لانتقال مركز الحضارة من منطقتنا إلى الغرب، وتعويض هذا الشعور بالإصرار على ضرورة التمايز "حضارياً"، وليس "ثقافياً" وحسب، عن الغرب، رغم أننا لم نعد نملك الكثير من المقومات التي تؤهلنا لأن نكون مركزا لتلك الحضارة. ويزداد الطموح لاسترداد هذه المكانة مع الإحساس المتزايد بأن سيادة الغرب بدأت في التراجع، وأن مركز الحضارة قد ينتقل إلى مجتمعات أخرى في المستقبل غير البعيد، وهو الأمر الذي أشار إليه الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ول ديورانت في موسوعة قصة الحضارات التي بدأ نشرها في منتصف خمسينيات القرن الماضي. لقد أحدث ديورانت بموسوعته ثورة علمية، بتعبير توماس كون في كتابه بنية الثورات العلمية في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الأكاديمي الأمريكي والغربي، إلى أصول الحضارة العالمية المعاصرة، والتي يعتبرونها أصولا يونانية ورومانية، ويبخسون الدور الذي لعبته حضارات أخرى سابقة، لاسيما حضارات الشرقين الأدنى والأقصى والحضارات الأسيوية وحضارات العصر الوسيط، وفي مقدمتها الحضارة الإسلامية التي كانت بحق حضارة عالمية. فموسوعة ديورانت التي حملت عنوان "قصة الحضارة"، هي محاولة من جانبه للتصدي للتعصب الأعمى الذي يسود الكتابات الغربية التقليدية للتاريخ باعتبار اليونان هي بداية التاريخ الحضاري للبشرية، من خلال تقديم نموذج إرشادي جديد للنظر إلى مسألة الحضارة، وأحسب أننا في حاجة ماسة إلى جهد مماثل للتفكير في مسألة الحضارة.
حضارة واحدة وثقافات متعددة
يطرح الدكتور عادل القليعي في مقاله المنشور على موقع المشهد، يوم 11 مارس، تساؤلاً مهماً: لماذا "نقول نحن والغرب؟" ويتبعه بتساؤل آخر: "متى سنقول جميعنا؟" إلا أن السؤال الذي افتتح به المقال: "لماذا لا يحدث انصهار وذوبان الآخر فينا ونحن فيه؟"، يرسخ لدي الاقتناع بضرورة إعادة طرح مشكلة الخلط بين الحضارة وبين الثقافة، وما يترتب على هذا الخلط من نتائج، في مقدمتها مقولة "أنا والآخر". إن طرح المسألة على هذا النحو يُخرج أي حوار جاد مع الغرب لإيجاد أرضية مشتركة عن مساره، ويعزز لدى مثقفيه الاقتناع بأن مثل هذه التعبيرات ومثل هذا الإصرار، إنما يعكس حقيقة أننا ننتمي إلى "حضارة مجروحة" في كبريائها، تركن إلى مجدها التاريخي الذي صنعته شروط لن تتكرر، ويعزلنا عن سؤال المستقبل باعتباره السؤال الرئيسي لأي حضارة، فالإنسان المتحضر يشغله أساساً سؤال المستقبل، فالانشغال بالمستقبل والاستعداد والتحوط له هو ما يميز الإنسان المتحضر عن الإنسان البدائي.
إننا بحاجة ماسة لضبط مفهوم "الحضارة" كنقطة انطلاق لتقدم الحواروالاشتباك مع ما يطرح من أفكار بخصوصها. فمفهوم الحضارة من أكثر المفاهيم غموضاً والتباساً، وهو أيضاً من أكثر المفاهيم التي يجري إساءة استخدامها، لأغراض سياسية. فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سبيل المثال، يؤطر حربه البربرية والوحشية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بأنها حرب من أجل الدفاع عن "الحضارة" ضد قوى تريد تدميرها. ووصف تلك بالبربرية دقيق في هذا السياق ذلك أن أحد السمات الأساسية للسلوك المتحضر المتمدين، التي يشير إليها ديورانت هي "رقة المعاملة"، وهو سلوك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور المدنية، التي منها اشتق مفهومي "المدنية" و"الحضارة"، وهما مفهومان يمكن استخدامهما بشكل متبادل، بينما لا يمكننا استخدام مفهوم الحضارة للإشارة إلى الثقافة والعكس. من هنا، تشتد الحاجة إلى وضع تعريف علمي ودقيق لما تعنيه كلمة "الحضارة".
في موسوعته "قصة الحضارة" التي ضمت 42 جزءاً، يتتبع ديورانت أصول الحضارة المعاصرة في حضارات الشرق القديمة، وخلافاً لبعض المفكرين الغربيين الذين يروجون لفكرة "المركزية الأوروبية" أو أولئك الذين يروجون لأي مركزية أخرى، لم يغفل ديورانت دور الشعوب والعرقيات المختلفة في صنع الحضارات المتعاقبة، مؤكداً "الطبيعة السيالة للحضارة البشرية" ، التي تبرز أن الحضارة إنما تنشأ من تبادل الخبرات والاتصال والسعي الإنساني، وهو ما أشار إليه الدكتور محيي الدين صابر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تقديمه للترجمة العربية لموسوعة ديورانت.إن قصة الحضارة أو المدنية كما كتبها ديورانت تبدأ من آسيا لكنها لم تنته هناك، فامتدت إلى أوروبا والعالم الغربي، فالحضارة عنده تلخص، باختصار، ما قاله الفيلسوف الفرنسي فولتير (1694 –1778) عن الخطوات التي سارها الإنسان في طريقه من "الهمجية" إلى المدنية، رغم تحفظ ديورانت على تعبير "الهمجية" أو "الوحشية" وتفضيله لاستخدام تعبير "البدائية". ويرى أن استخدام ألفاظ مثل "الهمج" أو "المتوحشين"، وصف بعض الناس لا يعبر عن حقيقة موضوعية قائمة، وإنما عن حكم قيمي.
والحضارة وفقا له هي نظام اجتماعي يُعين الإنسان على الزيادة من انتاجه الثقافي وتتألف من أربعة عناصر، هي الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون، وتبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق وعندما يتحقق للإنسان الأمن من الخوف ويحرر دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء لديه ليمضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها. وتتضافر عدة عوامل لتحفيز الحضارة أو إعاقة مسيرتها منها العوامل الجيولوجية والمناخية والعوامل الجغرافية وعوامل اقتصادية. ويميز بين الثقافة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالزراعة والريف، وبين "المدنية" أو "الحضارة"، التي ترتبط بالمدينة، حيث يتلاقى التجار ويتبادلون السلع والأفكار، وحيث تلاقح العقول الناشئ عن تلاقي طرق التجارة، فيرهف الذكاء وتستثار فيه قوته على الخلق والإبداع. المدنية تبدأ في كوخ الفلاح لكنها لا تزدهر إلا في المدن. والحضارة عنده لا تتوقف على جنس دون جنس، وهي التي تخلق الشعب، وتجئ بعد مرحلة يتم فيها التزاوج البطيء بين شتى العناصر، لينتهي، تدريجياً، إلى تكوين شعب متجانس نسبياً.
ويميز الدكتور حسين مؤنس بين "المدنية" أو "الحضارة" التي تدل على النظام الاجتماعي والتشريع الخلقي والنشاط الثقافي، وبين كلمة "ثقافة" التي تدل إما على ما يمارسه الناس فعلاً من ألوان السلوك وأنواع الفنون، وإما على مجموع ما لدى الشعب من أنظمة اجتماعية وعادات وفنون. ويوضح أن الثقافة هي التي تختلف وتتباين من مجتمع لآخر ومن فترة تاريخية لأخرى في المجتمع الواحد، أما الحضارة، خصوصاً إذا استندت إلى العلم واكتشافاته وحقائقه لا تتغير بتغير المجتمعات، والحضارة منتج مادي، وإن لعبت العوامل النفسية دوراً كبيراً في تشكيلها، فالكتابة والسينما والتلفزيون ووسائل الانتقال والاتصال هي منتجات للحضارة. في المقابل، فإن الثقافة مفهوم يعبر عن العادات والتقاليد المتوارثة. والحضارة بهذا المعنى واحدة ولا يمكن أن تتعدد بتعدد المجتمعات، بينما الثقافة متنوعة وتقبل هذا التعدد والتباين والاختلاف، فالثقافة نتاج مباشر للبيئة وظروفها المناخية والجغرافية والاجتماعية والسياسية، في حين أن المجتمعات المختلفة على تباينها الثقافي، تسهم بطريقة أو أخرى في صنع الحضارة الإنسانية من خلال سعيها لتطوير ما تنتجه وتحسين أساليب عيشها.
وعليه، فإن الأدق أن نتحدث عن صراع أو حوار بين الثقافات، لا بين الحضارات. وما أرى استخدام تعبير "الحضارة"، إلا نوعا من الاستخدام المدفوع برغبة في أن يكون الحوار على قاعدة من المساواة والتكافؤ، إلا أن هذا الأمر يُعقد الحوار ولا يساهم في تقدمه ولا يحقق لأطرافه أي مساواة أو تكافؤ غير قائم بالفعل، ويقلل الخلط بين الثقافة والحضارة، فرصة الإقرار بالتنوع والاختلاف فيما بين المجتمعات من حيث أساليب العيش وأنماط التفكير، بينما يساعد التمييز بين الحضارة والثقافة على الالتفات إلى مسألة الاختلاف وتقبله، أما الإصرار على الخلط بينهما، ينتج كثيرا من الالتباسات والغموض ويحول دون أن يؤتي الحوار ثمرته. وأشار الدكتور عمار في مقاله، إلى أن استخدام تعبير "الحوار الحضاري"، غالباً للإشارة إلى الحوار بين اتباع الديانات. إن استخدام مصطلحات دقيقة تعبر عن النشاط الذي ننخرط فيه بالفعل يساعد على بلورة الإشكاليات والتفكير في الحلول بشكل أفضل. قد تكون النقطة الأهم في مسألة الحضارة، هي نزوعها المستمر في أن تصبح عالمية ترتبط بالإنسان حيثما وجد، وهذا ما يؤدي إلى الخلط بين مفهوم الحضارة وبين الإمبراطورية، ونزعة التوسع الاستعماري.
الحضارة الراهنة: العلم والتفكير النقدي وسؤال المستقبل
يرى ديورانت الحضارة العالمية انتقلت من عصر الإيمان، الذي كان سمة رئيسية لحضارة العصور الوسطى، إلى عصر العقل، الذي ارتبط بحركة النهضة والإصلاح الديني والتنوير، وأخيراً عصر الثورة. والثورة التي تعني التغيير الجذري والمتسارع هو السمة الأساسية للحضارة الراهنة وتقوم على ثلاثة مقومات أساسية، هي العلم وما أحدثه من ثورة في التفكير، وفي أساليب الحياة عبر منتجاته وتطبيقاته، الذي شكل أساساً للتفكير النقدي باعتباره المقوم الثاني للحضارة المعاصرة، والذي يشير إلى أن البشر في حالة شك ومراجعة مستمرين لما لديها من أفكار، بسبب انشغالهم الكبير بسؤال المستقبل، وما تحدثه المقومات الثلاثة في تفاعلها من ثورات معرفية كبرى مع تقدم العلم في اكتشاف الكون وأصل الحياة وتطورها، الأمر الذي غير نظرة الإنسان للتاريخ وللحاضر والمستقبل. ولا يوجد مجتمع من المجتمعات بمنأى عن هذه الثورة وتداعياتها نتيجة للتوسع العالمي للرأسمالية وما أحدثه من ثورة في الاتصالات والتبادل بين المجتمعات. لقد أصبح العالم مع الانتقال إلى الألفية الجديدة أكثر ترابطاً وتعقيداً، نتيجة للعولمة التي حولت العالم إلى قرية صغيرة. وأحدثت هذه التغيرات تفاعلاً غير مسبوق بين المجتمعات المختلفة وثقافاتها، أتاحت مجالات للتعاون وللصراع أيضاً، فيما بين المجتمعات وداخلها. وأدت هذه التغيرات المتلاحقة والمتسارعة والجذرية إلى عدم اليقين وأدخلت تغييرات كبيرة على مفهوم الحقيقة، ولم تصبح الحقيقة ما يراه البشر، وإنما ما يسعى البشر إلى صنعه في المستقبل.
وعلى الرغم من التقدم الذي حققته المجتمعات الغربية في العلم وفي المعرفة، إلا أن انشغالها بسؤال المستقبل دفعها إلى التفكير فيما يشكله هذا التقدم من تهديد لمستقبلها ومستقبل البشرية، نتيجة لما أحدثه هذا التقدم من أثار بيئية تهدد العالم بكارثة يراها تتشكل أمام ناظريه، أو نتيجة لإساءة استخدام العلم وما استحدثه من منتجات على النحو الذي كشفه دخول البشرية في عصر الذرة، وما يحمله هذا الاكتشاف من مخاطر تهدد الوجود البشري على الرغم مما قد يوفره من منافع إذا أحسن العالم استخدامه وفرض القيود الأخلاقية لمنع إساءة استخدامه. لقد جعلت هذه التطورات العالم يلتفت إلى العوامل التي تقود إلى فناء المدنية أو الحضارة، بعد إدراكه أن الحضارة ليست شيئاً مجبولا في فطرة الإنسان، وإنما هي شيء لا بد أن يكتسبه كل جيل من الأجيال اكتساباً جديداً، وبعد أن أدرك حقيقة انتقال مركز الحضارة الإنسانية من منطقة إلى أخرى، ومن أمة إلى أمم أخرى، تقود عملية التراكم المنتج للحضارة الإنسانية، التي باتت بفعل التطور حضارة عالمية ودخلت في مرحلة الحضارة الكوكبية، مع تطور الوعي الكوكبي. وفي حين أدرك العالم هذه الحقيقة، نرفض نحن قبولها ونواجه العالم بادعاء حضاري مؤسس على فكرة الأخلاق، متناسين حقيقة أن الأخلاق لم تصنع الحضارة، وإنما كانت هي ذاتها نتاج للحضارة، التي تصنعها المساهمات المادية للبشر من خلال العلم والاقتصاد، ونتوهم أننا، وليس الصين قد نكون ورثة الحضارة الغربية الراهنة والتي يشير كثير من الفلاسفة والمفكرين أنها في مرحلة تراجع قد تؤدي إلى انتقالها إلى منطقتنا مرة أخرى، دون بحث العوامل التي قد تسمح بحدوث ذلك، فالحضارة تقوم على عوامل وشروط موضوعية لا بد من توافرها كي تتحقق، وهي ليست مسألة تمني أوأحلام. علينا أن نصارح أنفسنا ونجيب على السؤال، أين نحن من المقومات الثلاثة للحضارة العالمية الراهنة؟ إن هذا السؤال قد يكون جوهر السؤال المتعلق بالتحدي الذي يشكله الغرب بالنسبة لنا، والإجابة عليه قد تكون نقطة انطلاق مهمة لإعادة طرح مسألة "نحن والغرب" بطريقة نقدية. البداية من هنا، من حوارنا الصريح والصادق فيما بيننا وليس من حوارنا مع الغرب، سواء تصوره البعض حواراً حضارياً ورآه الأخرون حواراً ثقافياً.
----------------------------
بقلم: أشرف راضي